
تُظهر التجربتان العراقية والإيرانية أن قمع الاحتجاجات لم يكن نتيجة ظروف داخلية معزولة، بل جاء في إطار نقل نموذج أمني–عسكري متكامل من إيران إلى العراق، يقوم على إنشاء ودعم فصائل مسلّحة عقائدية تُستخدم لحماية المنظومة الحاكمة وقمع الحركات الاحتجاجية الرافضة للنظام السياسي القائم، وكذلك أي نشاط سياسي أو مدني أو حقوقي لا ينسجم مع توجهات السلطة. ولم يقتصر هذا النقل على السلاح فحسب، بل شمل العقيدة القتالية، وآليات التنظيم، وأساليب التعامل العنيف مع الاحتجاج السلمي، وترسيخ منطق الولاء العابر للحدود، حيث بات ولاء هذه الجماعات ظاهراً في خطاباتها وممارساتها.
في السياق العراقي، لم يكن اللجوء إلى الفصائل المسلحة إجراءً استثنائياً، بل سياسة ممنهجة تقوم على بناء قوى ولائية لا يرتبط ولاؤها بالدولة أو بسيادة القانون، بل بمراكز النفوذ السياسي. وقد تحولت هذه الفصائل إلى أداة رئيسية لقمع الاحتجاجات والأصوات المدنية والسياسية المعارضة، مدفوعةً بشبكة واسعة من الامتيازات والمصالح المالية والسياسية، حيث تسيطر على موارد حيوية كالنفط والمنافذ الحدودية وبعض مؤسسات الدولة، وتتغذى على حساب المواطنين، ما يجعل العنف وسيلة لحماية النفوذ لا لحفظ أمن الدولة.
السلاح كوسيلة للحماية العقائدية
شهد العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019 موجة احتجاجات شعبية واسعة جاءت نتيجة تراكم الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين فئة الخريجين والخريجات، فضلًا عن تدهور الخدمات العامة. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات، انتقلت المطالب من الإطار الخدمي إلى مطالب سياسية، تمحورت حول إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة، ورفض الفساد، والمطالبة بدولة مواطنة، تحت شعار "نريد وطن".
تُعدّ هذه الاحتجاجات ممارسة مشروعة للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، المكفولين بموجب الدستور العراقي لعام 2005، ولا سيما المادة (٣٨)، فضلًا عن التزامات العراق الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. غير أن تعامل السلطات مع هذه الاحتجاجات شكّل خرقاً جسيماً لهذه الالتزامات، إذ جرى اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة والسلاح الحي ضد متظاهرين سلميين عُزّل، في انتهاك واضح لمبادئ حقوق الإنسان.

وقد أسفرت عمليات القمع عن استشهاد أكثر من 500 متظاهر حسب احصائية المفوضية لحقوق الإنسان، إلى جانب ٢٤ الف جريح. كما شكّلت المجازر الموثّقة، ولا سيما أحداث ساحة الخلاني في بغداد، مثالاً صارخاً على انهيار منظومة الحماية القانونية للمتظاهرين، حيث اقتحمت مجموعات مسلحة ملثمة الساحة مستخدمة مركبات مدنية وأطلقت النار عشوائياً، مما أدى إلى مقتل 25 شخصًا وإصابة أكثر من 120 آخرين. وتكشف هذه الوقائع عن تداخل غير مشروع بين أجهزة الدولة الرسمية وفصائل مسلحة خارج الإطار القانوني، الأمر الذي يقوّض مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة.
إلى جانب ذلك، تعرّض ناشطو وناشطات الاحتجاجات إلى أنماط ممنهجة من الانتهاكات، شملت الاغتيالات، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وهي ممارسات تُصنّف قانونياً ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتمثّل اعتداءً مباشراً على الحق في التظاهر والمشاركة المدنية. ولا يزال مصير عدد من الضحايا مجهولاً حتى اليوم، ما يعمّق من أزمة العدالة الانتقالية في العراق.
يمكن القول إن احتجاجات تشرين شكّلت نقطة تحوّل مفصلية في تاريخ الحريات العامة في العراق بعد 2003؛ إذ كشفت عن هشاشة الضمانات الدستورية أمام منطق "الأمن العقائدي" واستخدام السلاح كأداة لضبط المجال العام. كما أبرزت هذه الأحداث التناقض البنيوي بين النصوص القانونية التي تكفل الحقوق والحريات، والممارسات الفعلية للسلطة الحامية للسلاح المنفلت.
مقاربة حقوقية تحليلية لاحتجاجات إيران
على امتداد التاريخ الاحتجاجي في إيران، شكّل القمع أداةً ثابتة بيد النظام الإيراني في مواجهة أي حراك شعبي، بغضّ النظر عن طبيعته أو مطالبه. ويعكس هذا النهج نمطاً ممنهجاً في إدارة الأزمات الداخلية قائماً على نزع الشرعية عن الاحتجاجات والتعامل معها بوصفها تهديداً أمنياً وعقائدياً، لا بوصفها تعبيراً مشروعاً عن مطالب اجتماعية أو اقتصادية.
فقد اندلعت موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران ابتداءً من 25 كانون الأول/ديسمبر 2025، على خلفية أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد. وكان التجار أول من نزلوا إلى الشارع، قبل أن تتوسع رقعة الاحتجاجات لتشمل مدناً رئيسية عدة، ما منحها طابعاً جماهيرياً واسعاً. غير أن ردّ النظام جاء منسجماً مع سوابقه، إذ لجأ إلى استخدام العنف المفرط بوصفه الخيار الأول في التعامل مع المحتجين، في انتهاك واضح للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان.
يتقاطع هذا النهج القمعي مع الأساليب التي استُخدمت في احتجاجات تشرين، حيث اعتمدت السلطات على القوة المميتة، والقمع المنهجي، بدل فتح قنوات الحوار أو الاستجابة للمطالب. وتشير تقارير حقوقية إلى استعانة النظام الإيراني بفصائل مسلحة عراقية موالية له في عمليات القمع، وهي فصائل تنظر إلى مطالب المحتجين بوصفها تهديداً مباشراً لأركان العقيدة الدينية التي يستند إليها النظام، وللبنية السياسية التي تغذّي نفوذ تلك الفصائل واستمرارها.
بعد مرور أسبوعين على الجريمة المنظّمة التي وقعت في 8 و9 يناير، اتلقّت قناة "إيران إنترناشيونال" موجة جديدة من الوثائق، والتقارير السرّية والميدانية، إضافة إلى روايات كوادر طبية وشهادات شهود عيان وعائلات الضحايا، تفيد بمقتل أكثر من 36 ألفًا و500 مواطن إيراني على يد القوات الأمنية. إلا أن هذه الجهود الحقوقية تواجه صعوبات كبيرة، أبرزها حجب الإنترنت، الذي يُستخدم كأداة لتقييد العمل الحقوقي ومنع توثيق الانتهاكات، ما يعكس سياسة متعمدة لطمس الحقيقة وتقويض مبدأ الشفافية.
تندرج قمع الاحتجاجات في الجانب الإيراني ضمن سجل طويل من المواجهات الدموية بين النظام والشارع الإيراني، الذي يخرج مراراً احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتقييد الحريات العامة، وفرض الوصاية الدينية على الحياة السياسية والاجتماعية. فأنه استخدامها لقمع ليس ردّ فعل ظرفي، بل سياسة ثابتة تهدف إلى الحفاظ على النظام القائم، ولو على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين.
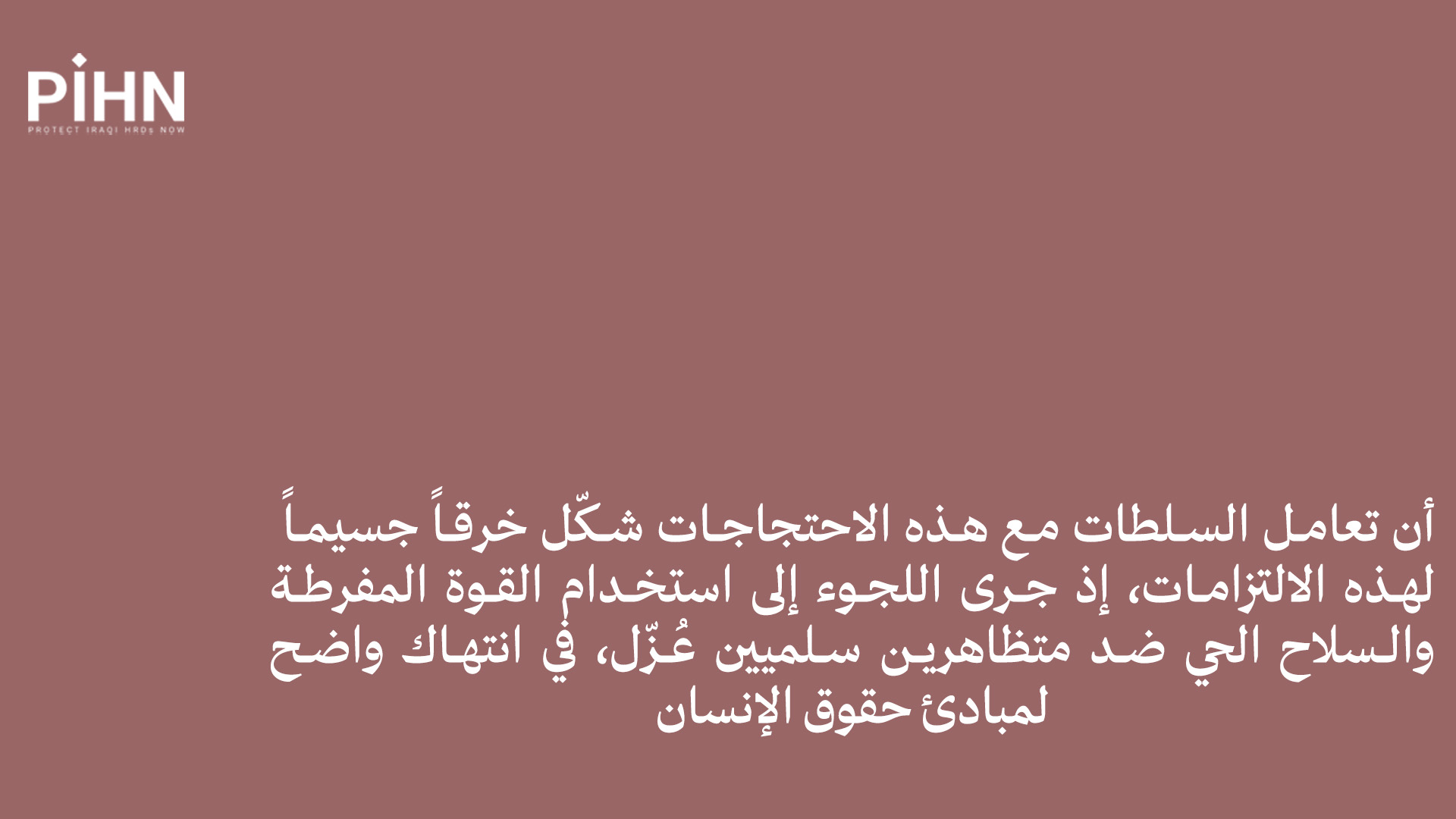
استنساخ التجربة أم توارد الأنماط القمعية؟
يكمن التشابه بين السياقين العراقي والإيراني في اعتماد التكتيكات القمعية ذاتها، وعلى نحو متكرر ومنهجي، شمل القتل المباشر للمتظاهرين، وقطع خدمات الإنترنت، واستخدام الترهيب والعنف المفرط لتفريق التظاهرات السلمية، فضلًا عن التعتيم الإعلامي ومنع تداول المعلومات. كما لجأت السلطات في كلا السياقين إلى بناء روايات رسمية تقوم على التخوين، وربط الاحتجاجات بمؤامرات خارجية أو "صهيونية"، في محاولة لنزع الشرعية عنها وتجريم المشاركين فيها.
وتصاعد هذا النهج ليشمل ممارسات تُعدّ انتهاكات جسيمة للحق في محاكمة عادلة، من خلال عرض تسجيلات مصوّرة لأشخاص جرى إجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية حول علاقات مزعومة مع أطراف خارجية، في خرق واضح لمبادئ حقوق الإنسان.
مما يثير هذا التشابه المتطابق تساؤلًا: هل هو مجرّد توارد في الأساليب القمعية بين أنظمة سلطوية متشابهة، أم أنه يعكس عملية استنساخ متعمدة لتجارب قمعية ناجحة من وجهة نظر السلطة؟ إن تكرار الأدوات، وتزامن الخطاب، وتداخل الأدوار بين الفاعلين الأمنيين والفصائل المسلحة العابرة للحدود، يرجّح الفرضية الثانية، أي وجود منظومة قمعية إقليمية تتبادل الخبرات والأساليب، وتعيد إنتاج العنف بوصفه أداة مركزية لضبط المجال العام.
وعليه، لا يمكن فهم ما جرى في العراق وإيران باعتباره أحداثًا منفصلة أو معزولة، بل بوصفه جزءاً من بنية قمعية عابرة للحدود، تتعامل مع الحريات العامة وحقوق الإنسان على أنها تهديدات يجب كسرها، لا حقوقاً أصيلة ينبغي حمايتها. ويضع هذا الواقع الحق في الاحتجاج السلمي أمام تحدٍّ وجودي، في ظل تصاعد نموذج أمني–عقائدي يسعى إلى تقويض أي تعبير جماهيري مستقل.


